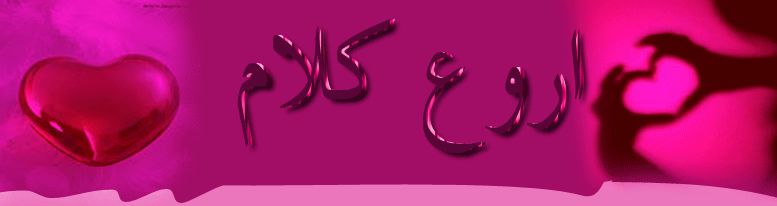لقد اتَّفق العمل الإسلامي على الالتزام المُجمل بالأصول التي تطرحها الدعوة السلفية من التوحيد والتزكية والاتباع ومحاربة البدع.
ولا يقف العمل الإسلامي بالتوحيد عند حدود الحديث في الصفات، أو في شرك الأموات، بل تجاوز ذلك إلى الإنكار على شرك الأحياء المتمثِّل في شرك الطواغيت القائمين على تبديل الشريعة الإسلامية، وتحكيم القوانين الوضعية.
ولا ينازع أحد في أهمية التزكية، وإن كانوا يتفاوتون في الأخذ بها -حسب توفيق الله لعباده- فإن الله قد قسَّم الأعمال كما قسم الأرزاق.
كما لا يُنازع أحد في أن الدليل الصحيح السالم عن المعارض لا يجوز ردُّه بقول أحد من الناس، وإذا وُجد من يتردد قليلاً في العمل بالحديث المخالف للمذهب، فليس هذا ترجيحًا منه للمذهب على الحديث، ولكن ذهابًا منه إلى أنه يجب التأكد من حصول المقتضى وعدم المانع؛ حتى يبرأ من العهدة وهو يردُّ بحديث واحد فتاوى الأئمة المعتمدة على النظر المعتبر في جملة النصوص.
وقد تنازعوا في تسمية العامي الذي يستطيع أن يفهم ما يلقى إليه من الأدلة مقلدًا أو متبعًا، ويمكن أن يستدل من كلام أهل العلم لهؤلاء وهؤلاء.
فقد أثبت ابن عبد البر وغيره من أهل العلم مرتبة الاتِّباع، وهي مرتبة بين مرتبة التقليد والبحث ومرتبة الاجتهاد، وتكون بالنسبة لمن يقدر على فهم الحجة من العامة، فقال: [والتقليد عند عامة العلماء غير الاتِّباع؛ لأن الاتِّباع هو: أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحَّةِ مذهبه، والتقليد: أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه]( ).
واعتبر شيخ الإسلام أن هذه المرتبة إحدى مراتب العامية، فقال بعد أن ذكر الخلاف في أهل الكتاب الذين تُؤكل ذبائحهم، وأنهم لا يشترط في أحدهم أن يكون جده من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل، فقال: [وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم، فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته، فإنه من العوام المقلِّدين، لا من العلماء الذين يُرجِّحون ويزيفون]( ).
فهناك إذا من يُفرد هذه المرتبة باسم الاتِّباع، وهناك من يجعلها إحدى مراتب العامية مع اتفاق الجميع على أن الاجتهاد جائزٌ في الجملة، وعلى أن التقليد جائزٌ في الجملة؛ الأول للقادر على الاستنباط والنظر، والثاني للعاجز عنه، وأنه لا حرج في التمذهب الخالي من التعصُّب باعتباره طريقًا إلى طلب الفقه، وأن العامي لا يصح له مذهب، وإنما مذهبه مذهب من أفتاه.
وأما محاربة البدع فهي موضع إجماع من المشتغلين بالعمل الإسلامي في الجملة ، وقد يقع نزاع جزئي حول اعتبار فعلٍ بعينه من البدع، أو عدم اعتباره، وإذا أثر عن بعضهم شيء من المرونة مع التصوف فمقصوده التصوف الشرعي المقيد بالكتاب والسنة على نحو ما كان عليه الجُنيد و الجيلاني وأمثالهم من الأئمة المهديين.
وإن كان من عَتب تأخذه بعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى على هذا الاتجاه فإنها تنحصر فيما ينسب إلى بعضهم من توجيه جُل اهتماماتهم إلى بعض المباحث النظرية في العقيدة، وضعف اهتماماتهم بقضايا الأمة المعاصرة؛ كقضية الدولة، والخلافة، وتطبيق الشريعة، والتصدي للتغريب ودعاة العلمانية، ونحوه، وأنهم قد يتشدَّدون مع المخالف من الاتجاهات الأخرى تشددًا قد يُفضي إلى الشحناء والتهارج.
وإذا صح ما يُقال من توجيه جل اهتماماتهم إلى المباحث العقدية البحتة، فماذا يضير بقية الاتجاهات أن تتخذ من هؤلاء كتيبة؛ لحراسة العقيدة وحراسة السنة في ساحة العمل الإسلامي، وأن تقتنع بمرابطتهم على هذا الثغر؛ ليرفعوا عن غيرهم إثم التفريط في أداء هذا الواجب أو التشاغل عنه، فيتكافل الجميع في أداء الفروض الكفائية، ويقنع كلٌّ بما قسم الله له، فإن الله -عز وجل- قد قسَّم الأعمال كما قسَّم الأرزاق، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله؟
أما التشدُّد الذي يُنسب إلى بعض هؤلاء، فالمأمول أن يرده القوم إلى أصول أهل السنة وإلى منهجهم في التعامل مع المخالف من التفريق بين مراتب البدع، ومراتب أهلها، واعتبار عارض الجهل والتأويل ونحوه، وأن يضبطوه بالقاعدة الشرعية في الموازنة بين المصالح والمفاسد، وإنهم لأهلٌ لذلك، ولا أرى إلا أنهم فاعلون إن شاء الله.
إن البغي هو المسؤول في كثير من الأحيان عمَّا يقع بين بعض فصائل العمل الإسلامي من الشقاق والتنازع.
فالاتجاهات السلفية ترى ضعف اهتمام الآخرين بالسنة تحقيقًا وتطبيقًا، وبالعقيدة تصحيحًا وتعليمًا، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يرون من هؤلاء الآخرين إنكارًا عليهم واستخفافًا بما انقطعوا له من إحياء السنة، وتصحيح العقائد ومحاربة البدع، وتزكية الأنفس، فيبادلونهم إنكارًا بإنكارٍ، وعند اللجاجة والمغالبة قد يتجاوز المرء حدود الإنصاف.
والاتجاهات الأخرى ترى قلة اكتراث هؤلاء بقضايا المواجهة؛ كقضية تطبيق الشريعة، وإقامة الدولة الإسلامية، والإعداد للجهاد، والمشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يرون منهم إنكارًا عليهم واستهانة بما يبذلونه على هذه الثغور العامة من الجهد، واستخفافًا بما يتعرَّضون له بسبب ذلك من البلاء، فيبادلونهم بدورهم إنكارًا بإنكارٍ، ويقع ما يقع من تهارج ومن مدافعة.
وهكذا تزداد الزاوية انفراجًا، ولو قنع كل بما قسم الله له، وآثر الإنصاف على البغي، ورأى في سعي أخيه امتدادًا لعمله، واستكمالاً لجهاده، وتداركًا لما فاته، وتناصح الجميع وتراحموا، لكان خيرًا وأشد تثبيتًا.
ويبقى البغي دائمًا هو المسؤول عن ذلك كله، وصدق الله العظيم؛ إذ يقول في محكم التنزيل: ] وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ[[البينة: 4]، وقوله: ] وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ [ [الجاثية: 17].
هذا، ولا يتنافى تخصُّص فريق من المسلمين في باب من أبواب الخير أن يتوافر لدى كل منهم من جميع هذه الأبواب ما يسلم به اعتقاده ما يبرأ به من العهدة، أما مازاد على ذلك من القدرة على الدعوة إليه، وإقامة الحجة به فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.